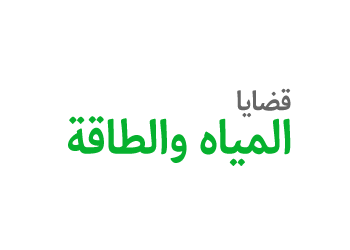ملف المياه بين الأردن وسوريا تاريخٌ طويل من الشدّ والجذب واتفاقيات لم تُنهِ كل الخلافات

استقبل وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، صباح الثلاثاء، في مكتبه معاون وزير الطاقة السوري لشؤون موارد المياه أسامة أبو زيد، رئيس اللجنة السورية الفنية للمياه، وأعضاء اللجنة، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المنعقدة في العاصمة عمّان.
شهد اللقاء حضورًا رسميًا أردنيًا واسعًا، حيث شارك الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، رئيس اللجنة الفنية الأردنية، والأمين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد، والأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء.
وخلال الزيارة، اطّلع الوفد السوري على تجربة الأردن المتقدمة في إدارة الموارد المائية، من خلال جولة في مرافق مركز السيطرة ومراقبة العمليات التابع لقطاع المياه. وقدّم المسؤولون الأردنيون شرحًا مفصلًا حول كيفية مراقبة السدود والخزانات ومحطات الضخ عن بُعد باستخدام أنظمة إنذار مبكر وتقنيات المشاهدة المباشرة، وهي أدوات تتيح التعامل السريع مع أي طارئ وضمان كفاءة توزيع المياه في مختلف المحافظات.
لاقى هذا النموذج الأردني تقديرًا واضحًا من الجانب السوري، الذي عبّر عن رغبته في الاستفادة من الخبرات الأردنية ونقلها إلى الداخل السوري، في ظل حاجة سوريا الماسّة لإعادة بناء بنيتها التحتية المائية التي تضررت بفعل الحرب المستمرة منذ سنوات.
ملف تاريخي معقد
تُعيد هذه الاجتماعات الدورية بين اللجان الفنية الأردنية والسورية إلى الواجهة ملفًا تاريخيًا معقدًا طالما مثّل واحدًا من أعقد أوجه العلاقة بين البلدين: ملف تقاسم مياه نهر اليرموك، الذي يُعدّ شريانًا حيويًا للزراعة والشرب في شمال الأردن وجنوب سوريا على السواء.
تاريخيًا، تعود جذور النزاع والتعاون في آن واحد إلى خمسينيات القرن الماضي، حين حاول البلدان تنظيم استغلال المياه المتدفقة من اليرموك عبر اتفاق أولي وُقّع عام 1953. غير أن هذا الاتفاق بقي حبيس الأدراج في كثير من بنوده بسبب غياب آليات رقابية فعّالة، فضلاً عن تباين التفسيرات بشأن ما يعتبر «استغلالًا عادلاً» للمياه.
وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تفاقمت الخلافات مع شروع سوريا في إقامة سلسلة من السدود الصغيرة والمتوسطة على مجرى النهر دون تنسيق كافٍ مع الأردن، وهو ما انعكس مباشرة على كميات المياه المتدفقة جنوبًا. من جانبها، اعتبرت عمان أن هذه المشاريع أحادية الجانب تمثل إخلالًا بالتفاهمات السابقة وتهديدًا مباشرًا لاحتياجاتها المتزايدة من مياه الشرب والزراعة، خاصة في محافظة إربد ووادي الأردن الذي يُعرف بكونه «سلة الغذاء» للمملكة.
ثم جاءت التسعينيات وبداية الألفية الجديدة لتشهد محاولات جديدة لرأب الصدع عبر اتفاقيات أوضح وأكثر تفصيلًا. كان أبرزها اتفاق 1987 الذي حاول تحديد الحصص المائية بشكل أكثر صرامة، ثم اتفاق 2001 الخاص بمشروع «سد الوحدة» المشترك، والذي اعتُبر في حينه إنجازًا استراتيجيًا لتأمين حصة مائية مستقرة للأردن مع تعزيز التعاون بين البلدين. ورغم هذه الخطوات الإيجابية، بقي التنفيذ محفوفًا بالصعوبات؛ إذ تأخر بناء السد لفترات طويلة، كما استمرت الخلافات بشأن حجم المياه الفعلية الواجب إطلاقها من الجانب السوري، خاصة في مواسم الجفاف.
إلى جانب ذلك، زاد المشهد تعقيدًا مع اندلاع الحرب السورية عام 2011، التي عطّلت معظم مشاريع التعاون المشترك، وأدت إلى تضرر البنية التحتية للمياه شمال النهر، فضلاً عن انشغال دمشق بأولويات داخلية أمنية واقتصادية. وفي المقابل، وجد الأردن نفسه يواجه أزمة مائية خانقة تفاقمت مع موجات اللجوء السوري وتزايد الطلب المحلي، ما جعل استعادة التعاون مع دمشق في مجال المياه أولوية ملحّة لعمان.
اليوم، وبينما يجدد الوفد السوري زيارته لعمان ويطّلع على تجربة الأردن في الإدارة المائية الحديثة، يبدو أن ثمة فرصة لإحياء روح التعاون الفني والعملي بعيدًا عن التجاذبات السياسية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات تحافظ على الحقوق التاريخية وتراعي في الوقت نفسه التحديات البيئية والمناخية التي تعصف بالمنطقة ككل.
واقع مائي شديد الحساسية
اليوم، يتفاقم الوضع بسبب ندرة المياه الناتجة عن التغير المناخي، وتزايد الطلب المحلي في كلا البلدين، فضلًا عن الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية السورية نتيجة سنوات الحرب. وفي هذا السياق، يبدو التعاون أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
يُعَدّ الأردن من أكثر دول العالم فقرًا بالمياه، إذ يُصنَّف منذ سنوات طويلة ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر معاناة من شحّ المياه. ويبلغ نصيب الفرد الأردني من المياه سنويًا أقل من 100 متر مكعب، في حين يُعتبر خط الفقر المائي عالميًا عند مستوى 500 متر مكعب للفرد في السنة، ما يعني أن الأردنيين يعيشون في حالة عجز مائي حقيقي.
تتفاقم الأزمة المائية في الأردن بفعل مجموعة من العوامل المتشابكة: التغير المناخي الذي أدى إلى تراجع معدلات الهطل المطري وعدم انتظامها، والنمو السكاني السريع الذي رفع الطلب على المياه، إضافةً إلى استضافة المملكة لأعداد كبيرة من اللاجئين، ما فاقم الضغوط على البنية التحتية المحدودة أصلاً.
يُعتمد في الأردن على مصادر مائية محدودة؛ أبرزها المياه الجوفية التي تشكّل أكثر من نصف إمدادات المياه، فيما تُستخدم السدود لتجميع مياه الأمطار الموسمية. إلا أن هذه السدود تعاني غالبًا من انخفاض مخزونها بسبب سنوات الجفاف المتعاقبة وتزايد الاستهلاك الزراعي.
كما يواجه الأردن تحديات كبيرة في تقليل الفاقد المائي الناتج عن الشبكات القديمة والتسربات، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 45-50% من المياه الموزَّعة لا تصل فعليًا إلى المستهلكين بسبب التسرب أو الاستخدام غير المشروع.
آفاق جديدة للتعاون
على الرغم من التاريخ المعقد الذي ميّز ملف المياه بين الأردن وسوريا على مدار عقود، تكشف الزيارة الأخيرة للوفد السوري إلى عمّان عن تحوّل ملموس في مقاربة هذا الملف؛ إذ بدا جليًا خلال الاجتماعات الأخيرة أن ثمة إرادة مشتركة لفصل الشأن المائي – الذي يمس حياة المواطنين يوميًا – عن الملفات السياسية والأمنية الأوسع، والتي تبقى بطبيعتها أكثر حساسية وتشابكًا.
هذا التحوّل يُعبّر عن إدراك متبادل بأن استمرار الخلافات أو ترحيل الحلول لم يعد ممكنًا في ظل التحديات البيئية والمناخية المتصاعدة. فقد دخلت المنطقة بأسرها مرحلة غير مسبوقة من الإجهاد المائي، جعلت التعاون الإقليمي خيارًا ضروريًا لا ترفًا سياسيًا. وهو ما انعكس في روح النقاش التي طغت على اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة، حيث لم يكن التركيز على تبادل العتب حول الماضي، بل على مشاركة الخبرات الأردنية في الإدارة الذكية للموارد المائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مراقبة السدود والخزانات وإدارة الطوارئ.
أهمية هذه اللقاءات لا تكمن فقط في كونها محطة تنسيقية، بل تفتح أيضًا الباب أمام مشاريع أكثر طموحًا قد تساهم في تخفيف حدة العجز المائي لدى الجانبين. من بين هذه المشاريع: تحديث أنظمة التحكم في السدود، والاستثمار في مشاريع حصاد مياه الأمطار، وتطوير محطات معالجة المياه العادمة لإعادة استخدامها في الزراعة، وهي تجارب يملك الأردن خبرة طويلة فيها يمكن أن تنقلها دمشق لتسريع تعافي قطاعها المائي المتضرر بفعل الحرب.
إضافةً إلى ذلك، يلوح في الأفق إمكانية التعاون في استثمارات مشتركة بمجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، لتغذية محطات الضخ والمعالجة، بما يقلل التكاليف التشغيلية ويزيد من مرونة هذه المنشآت في مواجهة انقطاع الكهرباء أو الكوارث الطبيعية. كما يمكن استكشاف حلول مبتكرة، مثل مشاريع تحلية المياه في المناطق الحدودية، أو إنشاء خزانات استراتيجية مشتركة للاستجابة لمواسم الجفاف القاسية.
ومع أن الطريق أمام هذه المشاريع لا يخلو من العقبات – سواء بسبب محدودية التمويل أو الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا – فإن مجرد التقاء الإرادة الفنية والسياسية على مبدأ «المصلحة المائية المشتركة» يشكل بحد ذاته خطوة كبيرة إلى الأمام. فهذا التعاون لا يحقق فقط فوائد مباشرة في تحسين الأمن المائي، بل يساهم أيضًا في بناء جسور ثقة أوسع قد تنعكس إيجابًا على ملفات أخرى، ويعزز من استقرار المنطقة ككل في زمن باتت فيه الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه، عنصرًا محوريًا في معادلات التنمية والأمن والسلام.
بين السياسة والجغرافيا
يبقى ملف المياه بين الأردن وسوريا مثالًا حيًا على التداخل العميق بين السياسة والجغرافيا. فعلى الرغم من فترات التأزيم والخلافات القديمة، تؤكد التطورات الأخيرة أن المصلحة المشتركة وإرادة التعاون يمكن أن تفتح الأبواب نحو شراكات مثمرة، خصوصًا في قطاع حساس يمسّ حياة المواطنين يوميًا.
وبينما تظل التحديات قائمة، فإن خطوات مثل هذه الزيارة والاجتماعات الفنية تمثل نافذة أمل لتعزيز الثقة وإعادة بناء علاقة مائية قائمة على الشفافية والإنصاف والاحترام المتبادل.